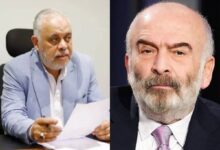قبل 142 عامًا، انطلقت أول دعوة لتشكيل برلمان مصري، وتشير التقارير إلى أنها جاءت في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر 1881م. وعلى ذلك افتتحت جلسات المجلس الذي كان يسمى آنذاك “البرلمان المصري” في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول. لسنة 1881، ولكن ما هو أقدم تشريع في تاريخ البشرية؟
منذ حوالي 5200 عام، تمكن الملك مينا، مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى، من توحيد الجانبين القبلي والبحري (جنوب وشمال) مصر في دولة موحدة، وأنشأ أقدم النظم التشريعية في تاريخ البشرية عندما جعل الدولة قانون “تحوت” إله الحكمة، القانون الموحد السائد في مصر كلها. أصبحت مدينة ممفيس العاصمة والمركز الإداري لأول دولة مركزية موحدة في التاريخ، وتمتلك جهازًا منظمًا في الحكم والإدارة والقضاء والتعليم والشرطة والجيش وغيرها. .
وتدل آثار الحضارة الفرعونية على مدى التقدم الذي حققه المصريون في أنظمة الحكم والإدارة. وكان الملك “الفرعون” على رأس الدولة، وكان يعين أمين الصندوق الأكبر أو جابي الضرائب، وكان هناك عدد كبير من الموظفين الذين تم تعيينهم بأمر ملكي وترقيتهم إلى مناصبهم. ومنذ عصر الدولة القديمة، طبقت مصر أيضًا نظامًا ناجحًا للحكم المحلي، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.
منذ الأسرة الثالثة والرابعة للدولة المصرية القديمة، ظهرت مراسيم وتشريعات مختلفة، مثل التشريع الذي حدد ساعات عمل الفلاح، ومثل تشريع الملك منقرع الذي هدف إلى مكافحة السخرة. .
ويمكننا أن نرى مدى التقدم والتنوع في المهام التي تقوم بها الدولة من خلال مراجعة نقوش مقبرة “رخميرع” رئيس الوزراء ورئيس قضاة الملك تحتمس الثالث على جدران مقبرته في طيبة، كما أنها يحتوي على سجل كامل للتشريعات موضحا به عمل الوزير ومهامه. .
وفي عصر الدولة الفرعونية الحديثة، برز دور الملك حورمحب الذي يعتبر من أهم المشرعين في تاريخ البشرية، إذ تميزت تشريعاته بطابعها المدني البعيد عن الاعتبارات الدينية. كما اهتم بإصدار العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة، وكانت تشريعاته أول من أرسى فكرة الحريات والحقوق العامة، مثل حرمة المسكن، وحرمة المنزل. طريق. كما أكد على فكرة أن الوظيفة العامة هي خدمة للشعب وليست وسيلة للسيطرة عليه، وأن الموظف العام هو خادم الشعب وليس سيدا عليه..
وتركت الحضارة الفرعونية الكثير من الآثار والشواهد على هذا التطور الإداري والتشريعي، ومنها النص الموجود بمقبرة الأميرة إيدوتوس بمنطقة سقارة، والذي يعتبر أقدم تشريع ضريبي في التاريخ..
وكثيرا ما سجل المصريون القدماء على معابدهم ومقابرهم صور الملك وهو يقدم ماعت رمز العدل والقانون للآلهة، في إشارة واضحة إلى تقديس مفاهيم وقيم العدالة وسيادة القانون..
وبعد دخول الإسكندر الأكبر مصر عام 330 قبل الميلاد، بدأ الحكم اليوناني في مصر، وبعد وفاة الإسكندر جاءت فترة الحكم البطلمي ثم الحكم الروماني. وعلى الرغم من قسوة الحكم الروماني، إلا أن المصريين تمكنوا من الحفاظ على معظم تقاليدهم وأنظمتهم وعاداتهم حتى دخلت المسيحية مصر في النصف الأول من القرن الأول الميلادي، حيث ساهمت الكنيسة المصرية في ترسيخ العديد من الأنظمة والتقاليد .
وفي العصر الإسلامي، كانت أنظمة الحكم والتشريع مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، استناداً إلى مبدأ الشورى الذي يعد من المبادئ الأساسية في أنظمة الحكم في الإسلام. .
وعندما أصبحت مصر عاصمة الخلافة الفاطمية (969-1171م)، تطورت أنظمة الحكم والتشريع، وتم التخطيط لمدينة القاهرة لتكون عاصمة مصر والخلافة الإسلامية..
وفي عهد الدولة الأيوبية (1171 – 1250م)، أصبحت القلعة مقراً للحكم ومركز السلطة، وتنوعت المجالس التشريعية والقضائية. وتم إنشاء مجلس العدل ومجلس النظر في التظلمات وغيرهما. وتضمنت أعمال هذه المجالس إصدار التشريعات والقوانين وإبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية. .
وفي العصر المملوكي (1250 – 1517) بنى السلطان الظاهر بيبرس دار العدل في قلعة صلاح الدين الأيوبي ليكون مقراً للحكم. وشملت صلاحيات مجلس الحكم في تلك الحقبة إصدار التشريعات وتنفيذها، وحل النزاعات، بالإضافة إلى إجراء المفاوضات مع دول الجوار. .
وفي العصر العثماني (1517 – 1805) كانت المحاكم الشرعية هي النظام المطبق في مصر، وكان القضاة يطبقون الأحكام من الشريعة مباشرة على كافة المنازعات المدنية والجنائية والمسائل الشرعية، وظل هذا الأمر قائما حتى نهاية القرن الثامن عشر. قرن. .
شهدت مصر في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر تطورات سياسية واجتماعية مهمة على مستوى الفكر والممارسة .
وفي عام 1795، أي بعد أقل من ست سنوات على الثورة الفرنسية، شهدت القاهرة انتفاضة اجتماعية وسياسية كبرى من أجل الحقوق والحريات وسيادة القانون، برزت فيها مواقف القوى الوطنية والقيادات الشعبية من قضايا الشعب بشكل لا لبس فيه. والتي تبنت فيها طلائع هذه القوى المطالب الوطنية بالعدالة والمساواة والحرية. .
وفي سياق تصاعد المقاومة الشعبية ضد الوالي العثماني والمماليك، كانت مصر على مشارف ثورة شعبية واسعة أدت إلى انتزاع العلماء والقيادات الشعبية “حجة” مكتوبة من الوالي العثماني والمماليك. وكانت هذه الحجة مثل الماجنا كارتا، إذ كانت تطمح إلى وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والمماليك. وسلطة عدم فرض غرامات أو ضرائب إلا بموافقة علماء الأزهر ممثلين للشعب .